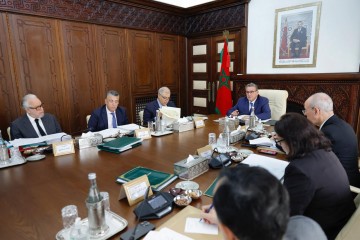وطنية
المعارضة البرلمانية المغربية: بين قوة الدستور وواقع الممارسة المتعثر.. هل فقدت القدرة على الفعل؟

خصص دستور 2011، ولأول مرة، فصلا كاملا لتكريس حقوق المعارضة البرلمانية، وتعزيز مكانتها كفاعل أساسي في تأطير المواطنين وإغناء النقاش العمومي، خطوة شكلت نقلة نوعية في المشهد السياسي المغربي. وقد جاء هذا التنصيص بعد طول انتظار، حاملا في طياته اعترافا دستوريا ومؤسساتيا بالدور المحوري للمعارضة.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكلية الحقوق بالمحمدية – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والقاضي السابق بالمحكمة الدستورية: إنها "المرة الأولى في تاريخ الحياة الدستورية، وعلى امتداد الدساتير الخمسة الأولى، لم يسبق للمشرع الدستوري أن تحدث عن شيء اسمه المعارضة حتى جاء دستور 2011، فدستر المعارضة ليدرج لأول مرة مصطلح المعارضة في الوثيقة الدستورية".
واعتبر أن اهتمام المشرع الدستوري بدسترة المعارضة وبيان حقوقها وواجباتها ليس مستجدا بسيطا أو مجرد تعديل ضمن مقتضيات جديدة تؤثث الدستور، بل هو مرتبط برؤية متكاملة ومتجانسة، وبالتالي فإن الحديث عنها ليس معزولا عن الرؤية المهيكلة للدستور المغربي.
ويشاطره الرأي الدكتور عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، قائلا: "إن دستور 2011 خطا خطوة هامة وغير مسبوقة في تكريس مكانة المعارضة البرلمانية، فتنصيصه على فصل خاص بحقوق المعارضة يمثل اعترافا مؤسساتيا بدورها الجوهري".
نناقش في هذا المقال التحليلي موضوع المعارضة البرلمانية بعد دستور 2011، من خلال تحليل الإطار الدستوري المؤسس لمكانتها، واستعراض أدوارها التشريعية والرقابية، وتسليط الضوء على اجتهادات المحكمة الدستورية ذات الصلة، فضلا عن رصد أبرز التحديات والآفاق الممكنة لتعزيز أدائها داخل المؤسسة التشريعية.

رشيد المدور
إرث دستــــوري وممارســـة واقعيــة
لقد عرفت المعارضة البرلمانية في المغرب تحولات بنيوية بعد المصادقة على دستور 2011، الذي شكل منعطفا محوريا في المسار السياسي والدستوري للبلاد، من خلال الاعتراف الصريح بمكانتها وضمان حقوق مؤسساتية لم تكن متاحة سابقا. فقد ارتقى بها الدستور من ممارسة سياسية ظرفية إلى عنصر بنيوي داخل البرلمان، وفاعل أساسي في مراقبة العمل الحكومي وصياغة السياسات العمومية.
غير أن هذا التحول النظري يصطدم، على أرض الواقع، بعدة تحديات ترتبط بثقافة الفعل السياسي، وبتمثل موقع الأغلبية والمعارضة، وبحدود تفعيل النصوص الدستورية فعليا.
وفي هذا الاتجاه، يرى الدكتور رشيد المدور أن من أهم ملامح التجديد التي جاء بها دستور 2011، هو دسترة المعارضة، موضحا أن التناوب الديمقراطي على السلطة لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود طرفين: الأغلبية والمعارضة. موضحا أن المعارضة لكي تحقق التناوب، عليها أن تعد نفسها وتعد البرامج البديلة للطرف الآخر الذي هو في الأغلبية، لذلك كان لا بد من طرفين في المعادلة: الأغلبية والمعارضة.
واعتبر المدور أن المشرع الدستوري، باعترافه بالطرف الثاني، أي المعارضة، كان حريصا على التنصيص على مجموعة من الحقوق والواجبات التي ينبغي أن تعطى لها لكونها الطرف المكمل لعملية التناوب الديمقراطي على السلطة. وقال: "أولى المشرع الدستوري اهتماما كبيرا للمعارضة لإنجاح عملية التناوب الديمقراطي على السلطة، فنص بشكل واضح أن المعارضة مكون أساسي من مكونات البرلمان. بمعنى أن عمل المعارضة هو عمل مشروع، يحترم المؤسسات، وينضبط للإطار القانوني والدستوري المنظم للعمل السياسي بصفة عامة".

عبد الله بوانو
مكانة المعارضة في الخطب الملكية
حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطبه السامية على التأكيد على تمكين المعارضة ومنحها المكانة التي يخولها لها الدستور، مقابل التشديد على ضرورة قيامها بدورها في البناء والمراقبة والمساءلة، كما ورد في خطابه السامي في افتتاح البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2011.
وفي 12 أكتوبر 2012، قال جلالة الملك من تحت قبة البرلمان: "تم تعزيز دور المعارضة البرلمانية كسلطة قائمة، بتمكينها من وسائل عمل جديدة، تخولها مشاركة أقوى وأكثر مسؤولية في العمل البرلماني".
وبعد عام، عاد جلالة الملك إلى الموضوع ذاته، داعيا في افتتاح السنة التشريعية في 11 أكتوبر 2013 إلى "إخراج النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية، لتمكينها من النهوض بمهامها في مراقبة العمل الحكومي، والقيام بالنقد البنّاء، وتقديم الاقتراحات والبدائل الواقعية بما يخدم المصالح العليا للوطن".
وفي هذا الصدد، يقول الأستاذ محمد النضر، أستاذ علم السياسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – عين الشق، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء: "بالفعل تم إصدار النصوص المتعلقة بكيفيات ممارسة فرق المعارضة لحقوقها، عبر النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، وكذا القانون التنظيمي رقم 85.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق"، منوها "بالدور الإيجابي الذي لعبه المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا في مراقبتها لمدى دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، حيث قررت في العديد من الحالات بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بحقوق المعارضة، وآخرها القرار رقم 209/23 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب".

محمد النضر
إرث من المساهمة وقوة النصوص الدستورية
لا يمكن إغفال التاريخ العريق للمعارضة المغربية ومساهماتها القيمة في الحياة السياسية، حتى في أحلك الظروف. فمن خلال نظرها من زوايا مختلفة، وقدرتها على التحرر من بعض قيود السلطة التنفيذية، تنبثق رؤى واقتراحات تخدم الصالح العام.
ويشدد الدكتور عبد الله بووانو في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، على أن "للمعارضة تاريخا حافلا بالمساهمات في الحياة السياسية المغربية. إذ تتيح لها زاوية النظر المختلفة وتحررها أحيانا من قيود السلطة التنفيذية تقديم تصورات بناءة".
وقد عزز دستور 2011 هذه المكانة عبر مجموعة من المستجدات، كما يشير الأستاذ حسن النضر، أستاذ القانون بكلية عين الشق بالدار البيضاء، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، مبرزا أن الفصول 10 و60 و69 و82 تنص بوضوح على "حقوق تمكن المعارضة من ممارسة دورها الرقابي والنقدي البناء، وتقديم اقتراحات وبدائل واقعية".
ويوضح النضر أن هذه الحقوق تشمل "حرية الرأي والتعبير، والاجتماع، والحق في الإعلام العمومي، والحصول على التمويل، والمشاركة الفاعلة في التشريع والمراقبة، ورئاسة لجان دائمة، ودراسة مقترحات القوانين".
وأبرز المدور أن "لكي تقوم المعارضة بأداء واجباتها على النحو الأفضل والأمثل، كما يتوقع المشرع الدستوري، فقد كان واضحا ولافتا الفصل العاشر من الدستور، الذي يعتبر من أطول فصول الدستور، وخصصه بالكامل لبيان حقوق المعارضة. لكن، هناك ما هو أهم من الفصل العاشر، لأنه لم يزد ما كرسه نظري، باستثناء الإشارة إلى تخصيص لجنة أو لجنتين للمعارضة. فالأهم هو مظاهر التخفيف من قيود العقلنة البرلمانية التي كانت تشترط على أدوات الرقابة البرلمانية لممارسة أعمال الحكومة، لأن الأصل في الأدوات الرقابية البرلمانية أن المعني بها هي المعارضة، لأن الأغلبية مساندة للحكومة، فلا يتصور أن الأغلبية ستستعمل تلك الوسائل ضد الحكومة المساندة لها".
صعوبــــات الممارســة وتحديات الثقافة السياسية
رغم هذه الترسانة القانونية والدستورية، يواجه العمل البرلماني صعوبات متعددة تحد من فعالية المعارضة.
وفي هذا السياق، عبر الدكتور بووانو عن أسفه قائلا: "رغم ما يوفره الدستور والنظام الداخلي من آليات، نصطدم أحيانا بمحاولات لتقويض حضورنا وتفريغ مبادراتنا من محتواها أو الالتفاف عليها، سواء من طرف الحكومة أو الأغلبية البرلمانية".
وأضاف: "تتجلى هذه المحاولات في عدم التفاعل مع مقترحات القوانين التي نتقدم بها، ورفضها دون مبررات، وينسحب الأمر على طريقة تعاملها مع مبادراتنا الرقابية، حيث لا يزال رئيس الحكومة يرفض المثول أمام مجلس النواب مرة في الشهر في إطار الجلسة الشهرية، ونسجل الغياب الدائم لعدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، بالإضافة إلى ضعف التجاوب مع طلبات المعارضة..".

أحمد التويزي
ملتمس الرقابة: فشل أم مؤشر على الضعف؟
أثار فشل المعارضة البرلمانية في تقديم ملتمس رقابة ناجح، مؤخرا، تساؤلات حول قدرتها على تفعيل أدواتها الدستورية. هل هو فشل عابر، أم مؤشر على ضعف بنيوي واستراتيجي؟
المحلل السياسي و أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، محمد الساسي، وأحد رموز المعارضة، يقدم قراءة نقدية في تصريح لـ»الصحراء المغربية»، قائلا: «الصعوبة تكمن في وجود معارضة قوية، لأن الأحزاب الأساسية جميعها سبق أن شاركت في الحكومة، مما جعلها تتشابه في خطابها وهياكلها وممارستها، ما أضعف إمكانيات التمايز».
ويضيف «حينما يصبح الانضمام للحكومة متاحا أمام الجميع، في الظروف العادية والاستثنائية، لا يعود هناك تباين استراتيجي يبرر بروز معارضة قوية، ولهذا من الصعب أن توجد اليوم معارضة بالقوة التي كانت في الماضي».
وبالعودة إلى ما أتاحه الدستور للمعارضة لممارسة الأدوات الرقابية البرلمانية، قال الدكتور المدور «الثورة التي أحدثتها المشرع الدستوري لسنة 2011، هو أنه سهل ولوج المعارضة إلى استثمار واستعمال الأدوات الرقابية، وهو ما عبرت عنه بالتخفيف من قيود العقلنة البرلمانية».
ومضى قائلا «بتتبعنا الأنصبة التي كانت مشروطة لممارسة الأدوات الرقابية، نجد أن المشرع الدستوري عمل على التخفيف منها على نحو كبير جدا، بشكل يجعل المعارضة مؤهلة وقادرة على استثمارها، سواء تعلق الأمر بطلب عقد الدورات الاستثنائية للبرلمان، أو تعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق، أو تعلق بإحالة القوانين على الرقابة الدستورية، سنجد أن هناك تخفيضا واضحا في الأنصبة التي كانت مرتفعة في الدساتير السابقة، فأصبحت منخفضة بموجب الدستور الحالي، دستور 2011، لتسهيل ولوج المعارضة لاستثمار واستعمال هذه الأدوات الرقابية»، مشيرا منها إلى ما أورده الدستور من تخفيض الأنصبة بخصوص طلب عقد دورة استثنائية للبرلمان، أو تقديم ملتمس الرقابة، أو ملتمس المساءلة، الذي هو خاص بمجلس المستشارين، فضلا عن تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والإحالة الاختيارية على المحكمة الدستورية للقوانين للبت في مدى دستوريتها، معتبرا أن «هذا التخفيض الذي مارسه المشرع الدستوري على الأنصبة التي كانت تشكل عائقا عمليا وواقعيا أمام المعارضة لكي تمارس أدوارها المنوطة بها، فهو ليصبح في مقدور ومكنة المعارضة استعمال وسائل الرقابة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية».
وعرج على الفصل 61 من الدستور قائلا «جاء هذا الفصل تحصينا للأغلبية من جهة، ولكن تحصينا أكبر وأكثر للأقلية، وهي المعارضة»، مشددا على أن المشرع الدستوري راعى من خلال ما سبق ذكره، أمرين اثنين «أولا، خفض من الأنصبة لكي تستطيع الأقلية، وخاصة الأقلية المعارضة، أن تمارس تلك الوسائل. وثانيا، حصن هذه المعارضة بأن ضيق الفرص أمام الذين يهاجرون ويتركون فرقهم من أجل الانتماء إلى فرق الأغلبية».
على مستوى الممارسة، استعرض المحلل السياسي محمد الساسي، أربعة مراحل بارزة لتبيان تجربة المعارضة البرلمانية المغربية قبل وبعد دستور 2011 قائلا: «المرحلة الأولى: جاءت بعد انتخابات سنة 1963، حيث كان هناك شبه توازن بين فريق الأغلبية وفريق الموالاة. وقد خلق هذا التوازن احتمالا لتحول الأغلبية من فريق إلى آخر، وهو ما اعتبر حينها وضعا محفوفا بالمخاطر، وانتهى بحل البرلمان – بغض النظر عن طبيعة الحكومات القائمة آنذاك.
المرحلة الثانية: بدأت مع برلمانات ما بعد سنة 1977، حين تبنت الأحزاب السياسية المغربية ما سمي بـ»الانتقال الديمقراطي». في هذه المرحلة، برز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي وأحزاب أخرى كمحور أساسي للمعارضة. ورغم أن الاتحاد لم يكن يتوفر على عدد كبير من المقاعد، إلا أن معارضته كانت نشطة، وذات خيارات سياسية واضحة، ولها مبادرات متنوعة، جعلت الحكومة في مواقف محرجة في عدة مناسبات، مكنت المعارضة حينها من لعب دورها القوي بفعل استقلالية عدد من الأحزاب، وتوفرها على منظمات جماهيرية فاعلة، مثل النقابات التي كانت إضراباتها تثير صدى قويا داخل البرلمان.
المرحلة الثالثة: بدأت مع تجربة حكومة التناوب، حيث انتقل الحزب الأقوى في المعارضة إلى قيادة الحكومة لأول مرة. وتحالفت الأحزاب التي كانت في صراع معه داخل المعارضة ضمن التشكيلة الحكومية نفسها. في هذه المرحلة، انتقل دور المعارضة إلى حزب العدالة والتنمية، الذي لم يكن يتوفر على المؤهلات نفسها التي كانت للاتحاد الاشتراكي، سواء من حيث الحضور داخل النخب المفكرة، أو من حيث الامتداد في منظمات جماهيرية فاعلة. وقد ركزت معارضته حينها على قضايا دينية، وبعض الأخطاء التدبيرية للحكومة، لكنها لم تكن بنفس الحدة أو الفعالية التي اتسمت بها المعارضة في المرحلة السابقة.
المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الحالية، إذ تعد الأصعب من حيث وجود معارضة قوية. ويعود ذلك إلى كون جل الأحزاب السياسية الأساسية قد شاركت في الحكومة، وتناوبت على مواقع المسؤولية. بل إن الكثير منها تعاون في حكومات متعاقبة، ما أفقد الحياة الحزبية الحدود الصلبة بين الأغلبية والمعارضة. فحينما تصبح المشاركة الحكومية متاحة لجميع الأحزاب، سواء في ظروف عادية أو استثنائية، فذلك يعني أن التمايزات الاستراتيجية والبنيوية بين الأغلبية والمعارضة باتت ضعيفة. وبالتالي يصعب اليوم الحديث عن معارضة برلمانية قوية بالمعنى الذي كانت عليه في مراحل سابقة من تاريخ الحياة السياسية بالمغرب.

محمد الساسي
أنظمة داخلية ذات قيمة قانونية
أكد الدكتور بوانو بالقول «أعتقد أن الدستور حسم في القوانين التنظيمية التي يتيحها، بحيث لم يأت على ذكر قانون تنظيمي خاص بالمعارضة، وإنما فصل في حقوقها في فصل خاص وهو الفصل 10، وعمليا الإطار القانوني الذي تمارس من خلاله المعارضة حقوقها هو الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، ومعلوم أن الحجية والقيمة القانونية للنظام الداخلي قوية وتوازي القوانين التنظيمية على اعتبار أنه هو الآخر يخضع للرقابة القبلية للمحكمة الدستورية».
مستقبل المعارضة: تجديد وتعاون
يرى الأستاذ الجامعي محمد النضر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، أن «النصوص تمنح المعارضة حقوقا واسعة، لكن عليها أن تتجاوز عائق العدد، وأن تبني استراتيجية اشتغال ناجعة تعتمد التكوين والتكتل وتطوير أدواتها».
ويدعو إلى «إعداد ملفات قوية مدعومة بالمعطيات الدقيقة، والتواجد الدائم في الساحة السياسية، وتعزيز التواصل مع الصحافة والفضاء الرقمي».
ويتفق معه أحمد التويزي، مؤكدا أن «الحياة السياسية تحتاج دائما إلى معارضة وطنية وجادة، وهذا النجاح مرهون أيضا بوجود حكومة مسؤولة قادرة على الإنصات واحترام أدوار المعارضة».
واعتبر الدكتور بوانو أن الحياة السياسية في حاجة دائما للمعارضة، شريطة أن تكون معارضة وطنية وجادة وموضوعية ومسؤولة، لكن أيضا في حاجة إلى حكومات وأغلبيات مسؤولة، مستوعبة للدستور وللسياقات السياسية، ومتمتعة برحابة الصدر، وتقبل النقد والانصات لملاحظات المعارضة وتنبيهاتها، وأن تعتبر ذلك نوعا من التقييم لسياساتها لكي تراجع ما يمكن مراجعته وتصحيح اختلالاتها، وتعديل زاوية نظرها للأمور ولقضايا الوطن والمواطنين.

في المحصلة، تتمتع المعارضة البرلمانية المغربية بترسانة دستورية وقانونية تتيح لها أداء دور فاعل ومؤثر. لكن واقع الممارسة لا يعكس بالضرورة هذه الإمكانيات، نظرا لهيمنة ثقافة سياسية ما تزال تقاوم منطق الشراكة الديمقراطية.
إن تعزيز دور المعارضة يتطلب جهدا مزدوجا، يتمثل في تطوير استراتيجيات موحدة داخل المعارضة ذاتها، وخلق مناخ سياسي يفسح المجال لتعددية حقيقية، بما يخدم الوطن والمواطنين على حد سواء.
-

مصرع عامل وإصابة 24 آخرين في انقلاب شاحنة بخنيفرة
الجمعة 03 أكتوبر 2025 - 11:56 -

اتصالات المغرب تتجاوز 81 مليون زبون عند متم شتنبر 2025
الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 10:50 -

مجلس جماعة الدار البيضاء .. دورة عادية بقرارات تتجاوز الطابع الروتيني
الجمعة 03 أكتوبر 2025 - 12:30 -

الصحراء المغربية.. غوتيريش يجدد تأكيد الدعوة إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 11:04 -

حافلات الدار البيضاء بإدارة ألزا تعلن عن تعديلات جديدة بشبكة خطوطها
الجمعة 03 أكتوبر 2025 - 12:31
-

مجلس النواب يعقد جلسة خاصة بخصوص قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية
السبت 01 نونبر 2025 - 17:08 -

تتويج الفائزين بجوائز الدورة الـ 15 للمسابقة الدولية للبيانو لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم
السبت 01 نونبر 2025 - 15:25 -

"إنوي" تكشف عن شعارها الجديد "سير بعيد" عبر برجي "التوين سانتر" بالبيضاء
السبت 01 نونبر 2025 - 15:19 -

انطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من المنح الموجهة لمتدربي التكوين المهني
السبت 01 نونبر 2025 - 11:20 -

الأندية تشارك الشعب فرحته بعد اعتماد القرار الأممي حول الصحراء المغربية
السبت 01 نونبر 2025 - 11:12